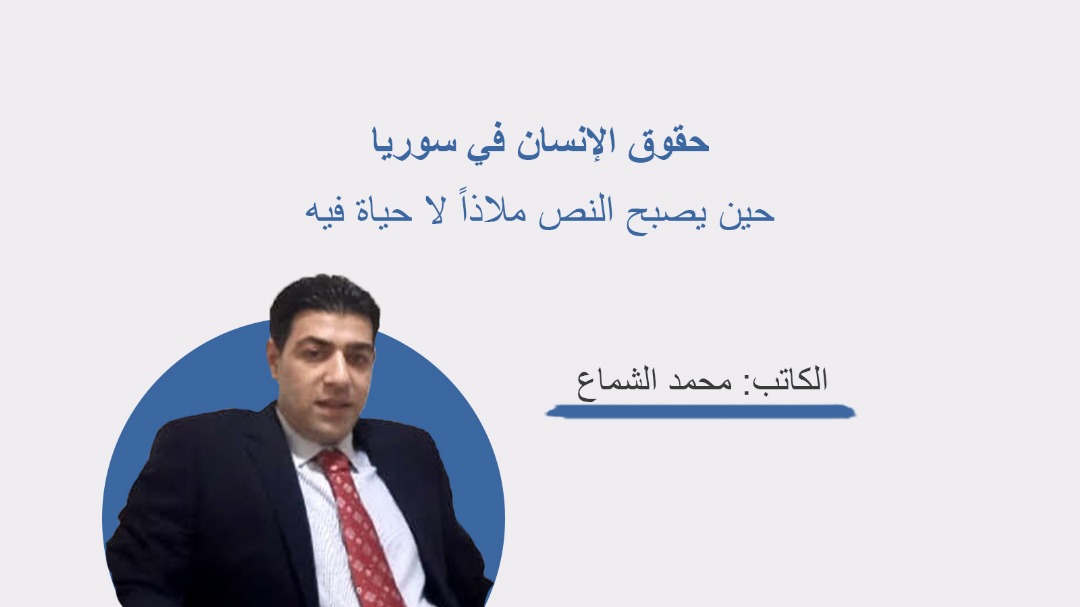حقوق الإنسان في سوريا: حين يصبح النصُّ ملاذًا لا حياة فيه
- updated: 30 يوليو 2025
- |
*محمد الشماع
منذ أن ولدت الجمهورية السورية من رحم الاستقلال، كانت الحروفُ الأولى في دستورها تنطق بكلماتٍ مُضيئة: “حرية، عدالة، كرامة”. كان ذلك الحلم مشرقًا، لكن الواقع سرعان ما غَسَله برمال قوانين الطوارئ والانقلابات، حتى بات النصُّ محجًّا يتيمًا، تُطرب له الخُطَب ويُدفن في التطبيق.
لقد تزيّنت سوريا، في كافة دساتيرها، بموادٍ تحفظ للإنسان حقوقه؛ حرية التعبير، المساواة أمام القانون، حقّ التظاهر، وصيانة الكرامة. لكنها كانت حقوقًا ترتدي الزي الرسمي في المناسبات، وتُخلع خلف الكواليس. تُدوّن في الشرائع وتُعلّق في المحافل، لكنها لا تلمس وجوه الناس، ولا تدفئ جراحهم.
ومن المفارقة أن سوريا صدّقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأدرجت هذه القيم في مناهجها المدرسية، لكن الطفل/ة الذي يقرأ عنها في الصف، يُعتقل حين يصرخ بها في الشارع.
تلك الازدواجية بين النص والواقع لا تُفسَّر فقط بمنطق السلطة، بل تُحاكي تكوينًا اجتماعيًا يُقدّم الولاء للزعيم، للعشيرة، للطائفة، أكثر من ولائه لفكرة الإنسان كفردٍ له الحق أن يكون حرًا دون إذنٍ من الجماعة.
كم من مرة خُنقت العدالة باسم “درء الفتنة”، وكم من مرة وُئدت المحاسبة لأن الجلاد من “أهلنا”؟ ليس النظام وحده من عطّل الحقوق؛ بل نحن، حين سوّغنا، وسكتنا، وتذرّعنا بالانتماء الضيق.
هذا الانتماء لا يمنح حصانة للكرامة، بل يُحوّلها إلى مكافأة تُمنح لمن يصمت أو ينتمي، ويُجرّدها ممن يجرؤ على السؤال. وهنا، تتجلى المفارقة: في بلدٍ يُحتفى فيه بالنصوص، يُعتقل الذين يؤمنون بها بصدق.
الثورة، في لحظة الانكشاف، لم تكن فقط صراعًا على السلطة، بل محاولةً لتفكيك هذه الثنائيات القاتلة: بين القانون والعرف، بين الدين والمصلحة، بين الطائفة والحق. لكنها اصطدمت بإرثٍ ثقيل، لم تُفلح في تغييره بالهتاف وحده.
الشرائع السماوية، من الإسلام إلى المسيحية، أكدت على كرامة الإنسان وحقه في العدالة والمساواة. في الإسلام مثلًا، ورد في القرآن الكريم: “ولقد كرّمنا بني آدم”، وفي المسيحية، تُعد المحبة والرحمة أساسًا للعلاقة بين البشر. هذه المبادئ، رغم وضوحها، لم تُترجم إلى تشريعات سورية تُلزم الدولة والمجتمع بحمايتها.
أما على المستوى الدولي، فقد صادقت سوريا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وانضمت لاحقًا إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لكنها لم تمنح هذه الاتفاقيات قوة دستورية، مما جعلها عرضة للتجاهل أو التفسير السياسي الأحادي.
من دستور 1950 إلى دستور 2012، وردت مواد تُؤكد على الحريات، لكنها غالبًا ما كانت معلّقة بحالة الطوارئ أو موؤودة تحت ضغط السلطة التنفيذية. المحكمة الدستورية العليا، وإن أُنشئت، لم تؤدِ دورًا حقيقيًا في حماية الحقوق، وأصبح القضاء تابعًا لا حَكمًا، مما قوض فكرة العدالة كمؤسسة مستقلة.
هنا يظهر العامل الأكثر تعقيدًا: المجتمع نفسه. التركيبة الاجتماعية السورية، المبنية على الطائفية والعشائرية والانتماء الضيق، ساهمت في تكريس الصمت بدل المساءلة. الفاعل إذا كان من “جماعتي”، فخطؤه يُغتفر، والانتهاك يُبرر. أما الآخر، فحتى حقه في الحزن يُصادَر.
يتحوّل الإنسان من كائنٍ له حقوق إلى مجرد تابعٍ لجماعةٍ تُحميه وتُوجّه ضميره. تنكسر فكرة المواطنة، وتضعف قيم القانون. العدالة لا تعني للجميع الشيء ذاته، بل تختلف حسب الجهة والهوية والانتماء، وهذه هي البذرة الأخطر في تعطيل الحقوق: أن يتحوّل الحق إلى وجهة نظر.
وفقًا لنظرية العدالة عند جون رولز، لا يتحقق العدل إلا حين تُمنح الحقوق للجميع، وتُوزع الفرص بالتساوي، وتُصمّم المؤسسات بطريقة تُقلّص التحيزات. سوريا، في المقابل، كانت تُكرّس التفاوت، وتُوزّع الامتيازات وفقًا للولاء السياسي أو الاجتماعي، لا للكفاءة أو الاستحقاق.
الثورة، حين اندلعت، كانت لحظة اختبار للضمير الجمعي. لكنها لم تكن ثورة على النظام فقط، بل أيضًا على العقلية التي سكتت عن الظلم حين طال الآخر، وبكت فقط حين نزل الجرح في خاصرتها. ظهرت جرائم موثقة، ونداءات للحرية، لكن كثيرًا من الأصوات برّرتها أو أنكرتها، لا لأنها غير موجودة، بل لأن الفاعل منها.
إن التحوّل الحقيقي يبدأ حين نكسر هذه المنظومة، ونُعيد بناء فكرة الإنسان كحق، لا كمكافأة. القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع، بصرف النظر عن الاسم والانتماء. التعليم يجب أن يُنقّي العقول من ثقافة المصلحة، ويزرع في الطفولة إيمانًا بأن “العدالة لا تحابي”، وأن “الحق لا يُؤجّل حتى يرضى القريب”.
حقوق الإنسان في سوريا لم تُمحَ، لكنها تُركت معلّقة بين النصّ والنية. نُصوصٌ تُجمّل الواقع في المؤتمرات، وتُنسى حين تُقرع أبواب السجون. والمجتمع، حين يُبرّر الجريمة إن كانت منه، لا ينتصر للحق بل ينتصر للظلم، ويترك النور حائرًا على العتبة.
نحن بحاجة إلى دولة، نعم، لكننا بحاجة أولًا إلى وعيٍ جماعي، يُحاكم نفسه قبل أن يُدين الآخر. نحتاج إلى مدارس تُعلّم الحقوق لا كمنجزات تاريخية، بل كقيم حياتية تُمارس كل يوم. نحتاج إلى إعلامٍ يُصفّي الخطاب من التحريض، وإلى تربية تُعلّم أن الحق لا يُشترى بالمواقف، ولا يُباع باسم الهوية.
فالحق لا يُمنح لأنه “منّا”، ولا يُسلب لأنه “منهم”. الحق يُولد مع الإنسان، ولا يُشرعَن إلا حين يُمارَس. والنص، إن بقي معلّقًا على الجدران، لا يُنقذ إنسانًا من الظلم، ولا يُعيد كرامةً سُلبت.
في سوريا، حقوق الإنسان لم تُقتل، لكنها تُركت على قارعة الطريق، تنظر إلينا كل يوم، تسأل: متى تُفعلني؟ ونحن نمرّ من أمامها، نمجّدها في الخطب، ونخاف أن نلمسها في الحياة. حين نكسر هذا الحاجز، وننزع الخوف من كفّ العدالة، نكون قد كتبنا بداية جديدة، لا على الورق، بل على لحم الذاكرة نفسها.